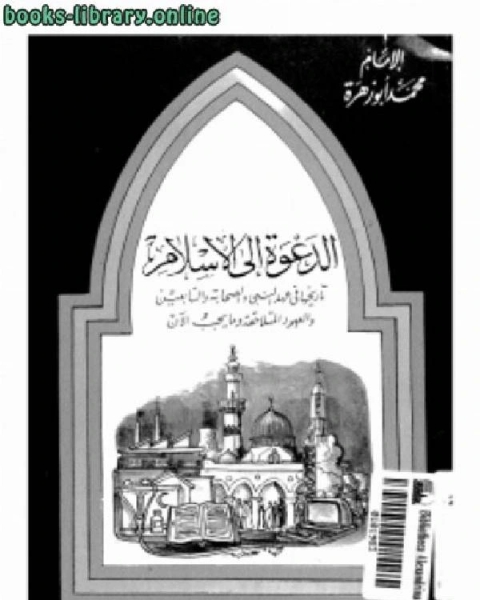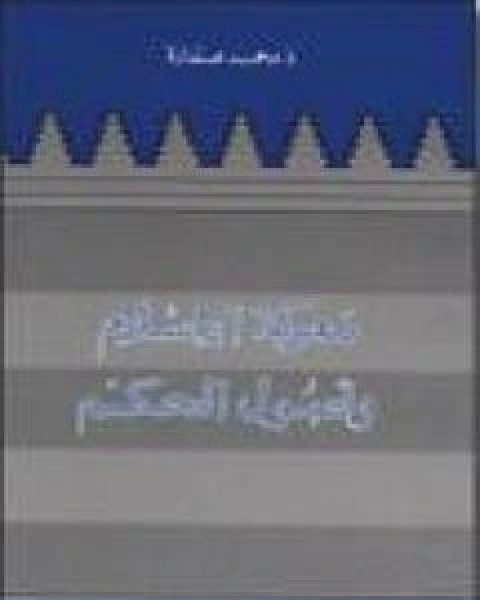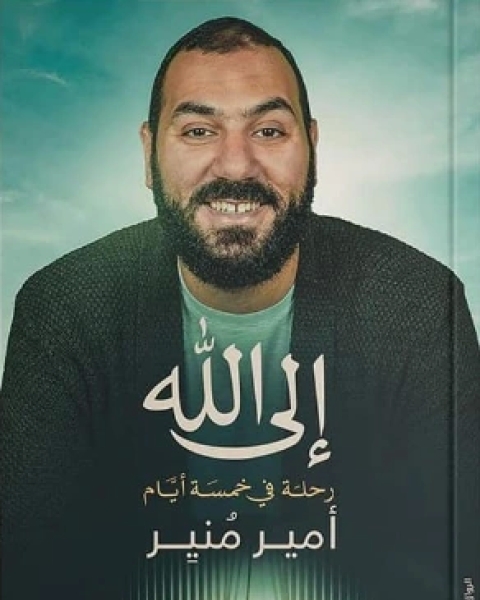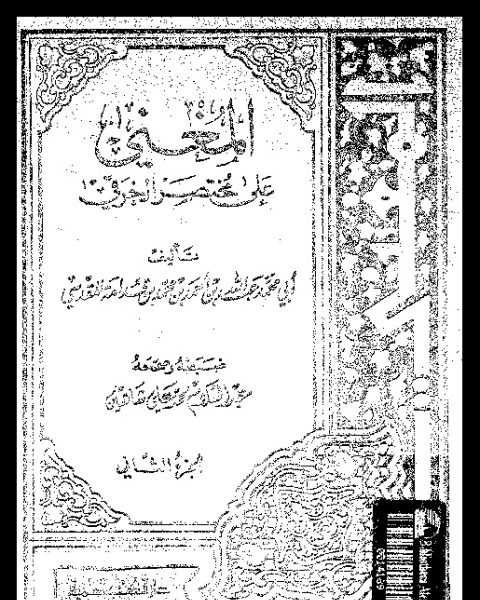تحميل كتاب المعجزة الكبرى القرآن نزوله كتابته جمعه إعجازه جدله علومه تفسيره حكم الغناء به PDF محمد بن عبد الله الزاحم
كتاب المعجزة الكبرى القرآن نزوله كتابته جمعه إعجازه جدله علومه تفسيره حكم الغناء به
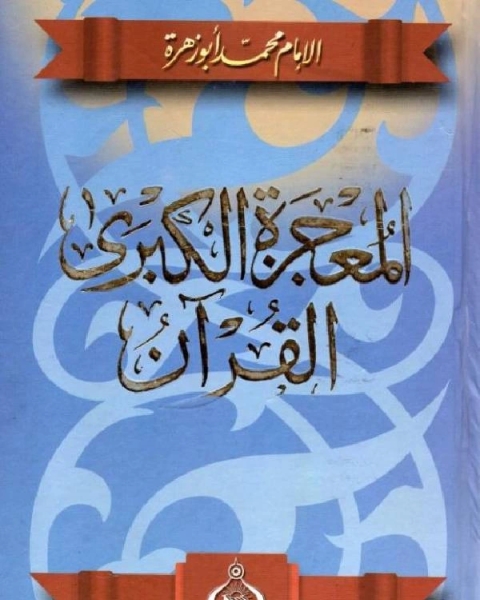
- إسم المؤلف:
- محمد بن عبد الله الزاحم
- عدد الصفحات :
- غير معروف
- إسم القسم :
- العلوم الإسلامية
- تاريخ النشر :
- غير معروف
- حجم الكتاب :
- 20.5 ميجا بايت
- نوع الملف :
- عدد التحميلات :
- 186
نبذة عن كتاب المعجزة الكبرى القرآن نزوله كتابته جمعه إعجازه جدله علومه تفسيره حكم الغناء به :
كتاب المعجزة الكبرى القرآن نزوله كتابته جمعه إعجازه جدله علومه تفسيره حكم الغناء به PDF محمد بن عبد الله الزاحم : اتجهت النفس متسامية إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتعرَّف سيرته الطاهرة العطرة لأقتبس من نور هديه، وأتنسَّم نسيم عرفه، ولا شاهد إرهاصات النبوة، بل الإعجاز في حياته الأولى، كما أيده الله تعالى بالمعجزات في حياته الثانية بعد أن بعث رحمة للعالمين، وقد تابعنا حياته -عليه السلام- الأولى، ثم تسامينا إلى متابعة حياته الثانية بعد أن نادَى في الجزيرة العربية بصوته القوي العميق يدعو إلى التوحيد في وسط الوثنية، وهو يصبر ويصابر، ويجاهد ويناضل، ويلاقي الأذى، والمؤمنون الصادقون الذين معه يعذَّبون، وقلوبهم بالإيمان لا ينطقون بالكفر، ولو مزّق الأذى أجسامهم، وطواغيت الشرك يتمتعون بالإيذاء، بينما أهل الإيمان يرضون بالعذاب عن الكفران، وقد أخذ النبي من بعد ذلك يعرض نفسه على القبائل، تمهيدًا لبناء دولة الإسلام الفاضلة في غير مكة، وأخذ النور يسري في ظلمات الجاهلية منبثقًا من مكة، وإن لم يستضئ أهلها بنوره لعمى البصائر، {فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} [سورة الحج: 46] . والمعجزة الخالدة التي يتحدَّى بها قريشًا وسائر العرب هي "القرآن الكريم"، رأينا من مساوقة الحوادث أن نتكلم في هذه المعجزة الكبرى، على أن يكون كلامنا فيها تبعيًّا وليس أصليّا، وبالعرض لا بالذات. 2- ولكن ما إن قاربنا نوره حتى بهرنا ضياؤه، واستغرض نفوسنا سناؤه، وانتقلت نفوسنا إلى الاتجاه إليه قاصدين ذاته أصلًا، لا تبعًا للسيرة، ولو كانت سيرة من نزل عليه القرآن وخاطب في ظله الأجيال، سيدنا الهادي رسول الله رب العالمين. وقد حاولنا أن نملأ نفوسنا من ينابيع الهداية فيه، وأن نشفي أمراض قلوبنا بما فيه من دواء، وأن نكشف الغمة بما فيه من حكم وعبر. لذلك صار القرآن وعلم القرآن، وكل ما يتعلق به هدفًا لنا مقصودًا، وأملًا منشودًا لا نبغي سواه، ولا نطلب غيره. فكان لزامًا علينا أن نخص كتاب الله ببحث ودراسة، وأن نخرج من ذلك البحث كتابًا نرجو أن يكون قيمًا في ذاته، وإن كان لا يعلو إلى حيث يكون مناسبًا لموضوعه، فموضوعه أعلى من أن تناهده همتنا، وأن تتسامى إليه عزيمتنا؛ لأنه كتاب الله تعالى، وأنَّى لضعيف مثلي أن يصل إلى وصفه أو التعريف به، إنه فوق منال أعلى القوى إدراكًا، وأعظم النفوس إشراقًا. "أ" وقد اتجهت ابتداء إلى بيان نزول القرآن منجمًا، وحكمته مستمدًّا هذه الحكمة من نص القرآن، وما أحاط بالتنزيل ووجوب حفظه في الصدور، ثم بينت أنه كتب في حياة الرسول، وأنَّ النبي -عليه السلام- كان يملي الآية أو الآيات التي تنزل عليه على كتَّاب الوحي، حتى إذا تمَّ نزوله كانت كتابته قد تمَّت، وقراءته بهذا الترتيب الذي نراه في الآيات والسور قد كملت، وقد تكلمت من بعد ذلك في جمع المكتوب في عهد الصديقين أبي بكر وعمر -رضي الله تعالى عنهما، ثم في عهد ذي النورين عثمان رضي الله تعالى عنه. "ب" وقد اتجهت إلى الحق في وسط ما أثاره بعض العلماء من خلافات حول أحرف القرآن الكريم، وقراءته ونزوله، وقد أسرف بعض العلماء على أنفسهم وعلى الحق، فأثاروا أقوالًا باطلة ما كان من المعقول إثارتها، حتى إنَّ بعض المغرمين بالجمع ونقل الخلاف قالوا أمورًا تخالف نص القرآن الكريم، فيما ذكر من نزلوه، وتهافتت الأقوال حتى وجدنا الذين لا يرجون للإسلام وقارًا يتعلقون بأقوال ذكرت لهؤلاء، كقول بعضهم: إن هناك رأيًا يقول: إن القرآن نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى واللفظ للنبي، ونسوا قوله تعالى معلمًا للنبي -صلى الله عليه وسلم القراءة والنطق بها: {لَا تُحَرِّكْ بِه لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} [القيامة: 16-19] ، فإن ذلك صريح في أنَّ القرآن نزل على النبي -صلى الله عليه وسلم- باللفظ والمعنى والقراءة، وأنَّ ذلك عليه إجماع المسلمين، والعلم به علم ضروري، ومن يخالفه يخرج من إطار الإسلام، وقد صرَّح القرآن الكريم بأنَّ الله تعالى هو الذي رتل القرآن، فقال تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا} [الفرقان: 32] . "ج" ولقد تكلمنا من بعد ذلك في إعجاز القرآن، وبيَّنَّا وجوه الإعجاز، ودفعنا القول بالصرفة دفعًا، ثم تكلمنا في علم الكتاب، وجدل القرآن، وتفسير القرآن، ومناهج التفسير، وبيَّنَّا التفسير بالأثر، ومقامه من التفسير بالرأي، وأنَّ الرأي يجب ألَّا يناقض المأثور، وأن التفسير باللغة والأثر مفتاح التفسير بالرأي. "د" وتكلمنا في الغناء بالقرآن وتحريمه، والتغنِّي الجائز المأثور، وإبطال ما سواه، وسرنا في طرق الحق الذي لا عوج فيه ولا أمت. 3- وإنا نحمد الله تعالى على ما اختبرنا به في أثناء كتابه ما كتبناه، لقد اختبرنا الله تعالى في أول كتابة ما كتبنا عن القرآن، فانقطعنا عن الاتصال بالصحف السيارة، نخاطب المسلمين من فوق منبرها، وقطعنا عن المجلات العلمية نوجّه الفكر الإسلامي من طريقها، ومن كل طرق الإعلام فلا نصل إليها، وكان الهمّ الأكبر أن انقطعنا عن دروسنا، وعن المحاضرات العامة. ولكن القرآن آنسنا في وحدتنا، وأزال غربتنا، فكان العزاء النفسي والجلاء الروحي، واختبرنا الله تعالى بالضر كما اختبر نبيه أيوب؛ إذ قال: {أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} [الأنبياء: 83] ، وإنه وإن تشابه المرض فإنه يختلف المقام، فهذا نبي يوحى إليه، ونحن من الأتباع، ونرجو أن نكون من الأبرار في اتباع النبيين، لزمنا المرض المقعد نحو شهرين، فكان ألم الابتعاد عن القرآن أكبر من ألم المرض الممضّ، ولقد منَّ الله تعالى بالشفاء، فخرجنا من الداء العقام، وما منعتنا وعثاء المرض، فعدنا إلى القرآن نقبس من نوره، ونعيق من عرفه، هو أنس المستوحش، وسمير المستغرب، فأنسنا بعد طول الغياب، ومنحنا الله تعالى به العافية، فوفقنا لأنَّ نقطع كل ما أردنا عرضه في مدة المرض، وكأنَّا في مجموع ما بلينا في طول المدة أصحَّاء في أبداننا؛ لأنه سلمت نفوسنا من السقام، بفضل القرآن. المعجزة الكبرى 1- يسير الكون على سنن قد سنَّت، ونظمٍ قد أُحكِمَت، وارتباطٍ بين الأسباب والمسببّات العادية لا يتخلَّف، وإن تخلَّفت المسببات عن أسبابها ووجدت الأمور منفكة عن علتها، كالولد يولد من غير أبٍ، وكالحركة تجيء من جامد لا يتحرَّك كعصا،، ونار تنطفئ وقد أوقدت، إذا كان ذلك الانقطاع بين الأسباب العادية ومسبباتها حكم العقل بأن الذي فعل ذلك فوق الأسباب العادية ومسبباتها، ولو ساير العقل منطقه إلى أقصى مداه "وليس بعيدًا في حكم المنطق العقلي المستقيم الذي يصل إلى المدى من أقرَّ به"، فإنَّه لا بُدَّ واصل إلى أن الذي خرق العادات وخالف أساببها ومسبباتها لا بُدَّ أن يكون خالقها وموجدها، وإذا كان القصور العقلي لا يصل إلى هذه الغاية، فإنه لا بُدَّ واصل إلى أن خرق هذه العادات، لا بُدَّ أن يكون لغاية، وأنَّه إذا وجدت هذه الغاية وبينت مقاصدها، وعلم أنَّ ذلك الخرق لهذه الغاية تبين معه صدق ما يدعى، وأنه يعلم من وراء ذلك الخالق الحكيم، المسيطر على كل شيء، الذي يفعل ما يرد، ولا يقيده نظام خلقه، ولا عادات أوجدها. لذلك كان الأمر الخارق للعادة حجة الصدق لمن يدَّعي أنه يتكلم عن الخالق الحكيم الفعَّال لما يريد؛ لأنه لا يغير العادات سواه، وإن الصادق يعلن دعواه، ويقيم ذلك برهانًا عليها، ويتحدَّى الناس أن يفعلوا مثلها، ويسمَّى في هذا الحال أنه معجزة. ولذلك عرفوها بأنها: المرّ الخارق للعادة الذي يدَّعي به من جرى على يديه أن نبي من عند الله تعالى، ويتحداهم أن يأتوا بمثله إن كانوا صادقين، وأن المعجزة المادية تتحدَّى بنفسها مع ادِّعَاء الرسالة، فإن النار لا تنطفئ من تلقاء نفسها؛ إذ يلقى فيها إبراهيم -عليه السلام- فتكون بردًا وسلامًا عليه فلا يحترق، وكالعصا التي تتحرك وتتلوَّى كأنها ثعبان مبين، وليست سحرًا كما أدرك الساحرون، وكانوا أول المؤمنين، وكإبراء عيسى للأكمه والأبرص بإذن الله، وكإحيائه الموتى بإذن الله، فما كان له أن يطلب منهم أن يأتوا بمثلها، والقصور بَيِّن والعجز واضح، ومع ذلك فالتحدي قائم، والعجز ثابت، والحجة قائمة، وكان عليهم أن يؤمنوا بالحق إذا جاءهم. .
إقرأ المزيد